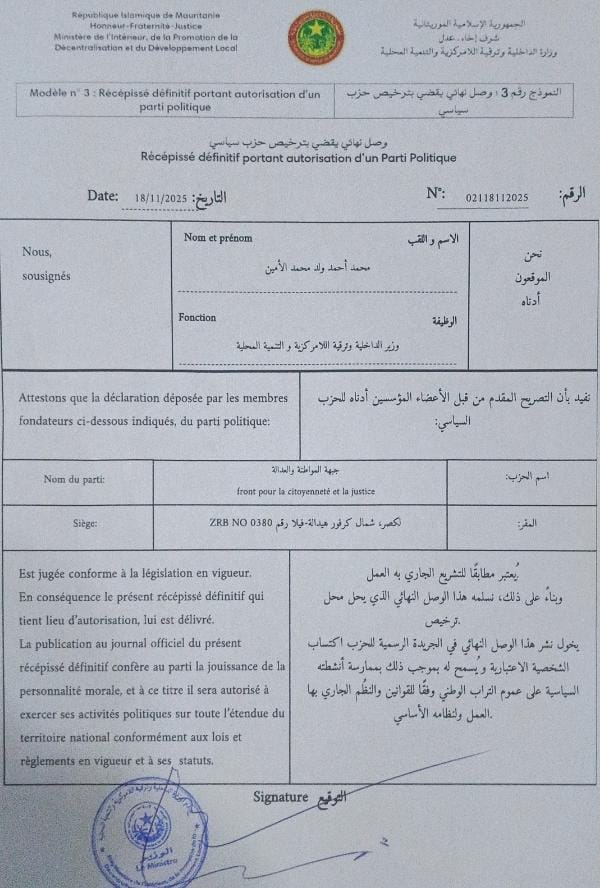يعيش العالم منذ بداية العام الحالي تحت كمامة الرعب والخوف من فيروس كوفيد 19، ذلك المخلوق غير المرئي بالعين المجردة، والذي أظهر إلى حد كبير ضعف القدرات الإنسانية، وانحراف قاطرة التنمية العالمية عندما توغلت في الخضوع للتقنية وعالم الآلة، ثم لم تنقذها قدراتها الهائلة، عندما انهارت أنظمتها الصحية أو كادت.
لقد بدا ظهور هذا الفيروس، وكأنه رد على تمادي هذا الإنسان الظالم نفسه عبر محاولاته اليائسة والهادفة إلى تغيير قوانين الكون وسنن الخالق، بهدم الغابات وتلويث البحار، وتكدير الأجواء والهواء الطبيعي، واستنزاف الثروات بشراهة ونهم.
كما تجاوز الحدود في محاولة تغيير الخلقة، عبر التوسع في محاولات الاستنساخ والتعديل الجيني للكائنات الحية، لقد تصرف الإنسان تجاه هذه النعم كما لو كان هو واهبها، أضف إلى ذلك استهداف الشعوب وقمعها بأبشع الوسائل، وخاصة الشعوب الإسلامية منها، وكل من طالب بالمساواة بين أبناء البشر، أو بالانعتاق السياسي.
وأضف إلى كل هذه الأخطاء سببا رئيسيا هو تغييب منهج الله تعالى عن التحاكم بين عباده، وتحييده عن تسيير العلاقات بينهم.
والسؤال هنا هو: هل سيواصل الإنسان تماديه بعد هذه النكبة المدوية في غيه ويتوهم أنه سيطر على هذا الوباء الجارف، كما توهم السيطرة على أوبئة أخرى مثل السيدا والأيبولا، أم سيأخذ الدروس ويعود إلى رشده، بنظرة مغايرة إلى ما كان عليه سلوكه، تجاه القوانين الطبيعية وسنن الله التي لا تتخلف ولا تحابي أحدا، وذلك باعتراف حضاري بأن للكون بارئا يعاقب من يحاول العبث بمخلوقاته
ولا شك أنه إذا اختار التمادي في غيه المعتاد سيكون من سلوكياته محولة تعويض خسائره المالية والاقتصادية، جراء مخلفات جائحة كورونا، من خلال نهب جديد لخيرات وموارد الشعوب الضعيفة، كما بنى منها اقتصاده ورفاهيته أول مرة، وهو ما يدعو إلى حلف وطني لحماية الثروات والدعوة إلى تعاضد الأمم والشعوب التي كانت دوما ضحية للنهب والاستعمار.
وكباقي الأمم نالت بلادنا للأسف الشديد نصيبا من هذه الجائحة المؤلمة، حينما تآزر عليها نظام صحي معدوم أو ضعيف الجدوى في أحسن التعبيرات تفاؤلا، ونمط تنمية لا يستطيع تسيير يوميات الحياة الرتيبة، أحرى أن يواجه الأزمات.
أما الوعي الشعبي الذي راهن عليه العالم من أجل مواجهة كوفيد19 فقد كان بالنسبة لنا جزء من صناعة الأزمة، وأسلوبا من أساليب التفشي.
لقد كشف كوفيد 19 بسرعة أن قطار تنمية البلد ومسار الحكامة الذي خضع له طيلة الستين سنة الماضية، كان مسارا خاطئا، وأن استمراره يعني مزيدا من الانهيار إلى هاوية لا يمكن لأحد أن يقدر مدى خطورتها.
ويذكرنا إعلان النصر على وباء كوفيد 19 خلال الشهر الأول من ظهوره في البلاد بنفس الدعاية التي أطلقت إبان حرب الصحراء المشؤومة، فحينها أعلن في الأسابيع الأولى أن النصر قد حسم، وأن ملف الحرب قد طوي، قبل أن يظهر أن الأمر بخلاف ذلك تماما.
كما أن نمط التصرف فيما جمعنا من أموال للتصدي لهذا الوباء يبدو مشابها، لتصرفات سابقة تجاه ما قمنا بجمعه لفلسطين من عون سنة 1967، ولحرب الصحراء سنة 1976، أو للمسفرين من السنغال سنة 1989، ليكون الأمر تأكيدا للمثل: مصائب قوم لقوم فوائد.
كما أظهر كورونا للأسف أن الأسئلة التقليدية التي طرحت نفسها أو طرحتها النخبة السياسية والشبابية والقوى الوطنية عشية الاستقلال لا تزال مطروحة في غالبها، سواء تعلق الأمر بإشكالات الهوية والمشترك الثقافي، أو أسئلة التنمية والحداثة، أو ضرورات الحياة من صحة وتعليم وماء وأمان غذائي.
وبدا جليا أننا رحلنا طيلة الستين سنة الماضية من واقع القبيلة والجهة وأحياء البادية إلى شبه دولة يحكمها نفس التفكير البدوي، وفي رحلتنا هذه لا نزال نحمل معنا تلك الشوائب المنافية للاستقرار وتلك الجراثيم المدمرة للنظام المناعي للدولة.
إن من الضروري اليوم أن تتنبه نخبنا السياسية والاجتماعية إلى أن سيرنا في ظلال الدولة انتقل من خيار سياسي إلى ضرورة حياة.
ولعل من الضروري الآن أن نعيد توطين سؤالي التنمية والسياسة في عمق النقاش وعمق الانتماء الفكري والحزبي والتداول السياسي بعيدا عن الخلفيات القبلية والإيديولوجية أو العرقية التي أطرت كثيرا من نقاشاتنا وأعاقتنا كثيرا عن ركب الأمم والشعوب المتقدمة.
لقد دفعنا ثمن هذه الإعاقة باهظا جدا، حين أظهرت أزمة كورونا عمق الهوة التي انحدرت إليه تنمية البلد، نتيجة اختلال سياساته، وتحكم الأحادية وضيق الأفق في التفكير السياسي الذي خضع له طيلة عقود، وتحويل مقدراته وثرواته العامة، إلى أملاك خاصة، عبر النهب المباشر للميزانيات والثروات، أو التهرب الضريبي، أو التحايل، أو الحصول على الامتيازات والمكاسب بطرق غير مشروعة، تثري بها زمرة محدودة، وتفتقر أمة وينهار وطن، وتنشأ مع الزمن قيم تمجد الفساد وتدور في فلكه.
وهاهو كوفيد 19 يوجه رسالة واضحة لأولئك الناهبين لثروة الشعب عندما أغلقت في أوجههم آفاق السفر، وأصبحوا رهناء وطن نهبوه وأفسدوه، فلا مدارس تحتضن أبناءهم ولا مستشفيات تداوي مرضاهم، ولا أسواق ترضي ترفهم، واتضح بالفعل أن المال وحده لا يغني ولا يسعد.
نحن اليوم في أمس الحاجة إلى انطلاق قاطرة جديدة، وما من شك أن النيات والبرامج التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يمكن أن تمثل قاعدة وطيدة للنهوض الوطني شرط تلافي وتدارك ما تعانيه من ضعف، وتخاذل في الانطلاقة.
نحن اليوم محتاجون إلى قيادة تعرف قيمة الزمن، وتخوض سباقا ضد تضييعه، هي قيادة تحدد سقفا للإنجاز وفق برنامج زمني محدد باليوم والشهر والسنة، بحيث تتضاعف إنتاجية كل موظف وكل قطاع.
وحاجتنا اليوم ماسة إلى قيادة قاسية على الفساد والمفسدين، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، وحتى يكون المال العام حرما آمنا تجبى إليه خيرات البلد، وتصرف منه بعدالة على العباد تنمية وصحة وتعليما وأمنا وإقلاعا حضاريا.
وإذا كانت الأنظمة السابقة قد نجحت في بناء طوابير من تجار الوشاية والنميمة، وإطلاق أسراب من المثمنين والمسبحين بحمد القائد، المنفضين عنه كلما سنحت لذلك فرصة، فإن حاجتنا اليوم هو بناء أغلبية من العقول المبدعة، وفريق سياسي وإداري من أولي القدرات الذين يمكن أن يقولوا وينفذوا ما ينبغي قوله وفعله من أجل التنمية والتقدم، وهم موجودون.
مؤسسة عسكرية ضامنة
وحاجتنا اليوم أيضا ماسة إلى إعادة تموقع المؤسسة العسكرية في صميم هرمية السلطة، بحيث تكون ضامنا أساسيا وحاميا للمسار الديمقراطي وللتنمية.
ولقد كان من المؤسف أننا عشنا منذ سقوط النظام المدني الأحادي سنة 1978 حالة مزيج من السلطة المدنية – العسكرية، فلم يكن العسكر بعيدين عن صراعات الأجنحة والحركات السياسية المدنية التي حاولت ونجحت في اختراق المؤسسة العسكرية والاستقواء بها أكثر من مرة في صراعاتها البينية، ولم تكن التشكيلات السياسية للمدنيين وخصوصا تلك التي أنشئت في ظلال السلطة بعيدة عن العسكر وتأثيرهم، كما ذلك كان جليا في هياكل تهذيب الجماهير وأحزاب السلطة الأخرى التي تعاقبت في المشهد السياسي وحتى الآن.
أنتج هذا التمازج السلبي بين العسكري والمدني حالة سياسية هجينة، فلم يعش البلد تحت سطوة وسلطان نظام عسكري صارم، يفرض القوانين والانسجام، وقد ينجح في تطوير وبناء منظومة اقتصادية قوية كما حصل في بعض دول العالم التي حكمها عسكريون متنورون، ولا نحن عشنا تجربة ديمقراطية فعالة وناضجة يديرها المدنيون، بشفافية وانسجام مع القوانين
وبسبب هذا وذاك ضاع أملنا في العدالة والتنمية، وفي الديمقراطية وتعثرت خطى الوطن.
من أجل نخبة وطنية.
يجدر بي وأنا من جيل من المسؤولين والسياسيين الذين أدوا أدوارا مختلفة في العقود الماضية، أن أقول وأؤكد أن الدور الأساسي الذي يرجى منا الآن هو التوبة إلى الله تعالي، ولندع محاكمتنا لذاكرة الأيام ولقلم التاريخ، أو لنظام جديد لم تتورط عناصره فيما تورطنا فيه.
إننا مطالبون بالتوبة بشروطها الأربعة من الإقلاع الفوري عن الخطيئة ورد المظالم الممكن ردها والندم على ما اقترفنا مع إخلاص النية في أن لا نعود إلى ممارسة الأخطاء أو الخطايا التي دفع هذا الشعب المسكين ثمنها ضعفا وفقرا وانهيار قيم ونهب ثروات.
أما ما يعرف بالأحزاب التاريخية أو الحركات الإيديولوجية، أو ما تبقى منها فهي محتاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير خطاباتها الفكرية لتكون أكثر ملاءمة لآمال وطموحات الأجيال الشابة ولفرص النهوض الوطني التي ضاعت أكثر من مرة بسبب غياب القوة الاقتراحية ومد جسور التفاهم بين مؤسسة الحكم وقوى المعارضة، نظرا لسيطرة الإقصاء أو الإلغاء على تفكير مختلف الأطراف، بينما تتسع الساحة لزراعة آمال التكامل والتوافق بدل أشواك القطيعة والتنافر التي أدمت أقدامنا طيلة سيرنا البطيئ والهجين نحو ما لم نصل إليه حتى اليوم.
تنمية مبدعة
يتأكد بشكل لا مراء فيه أن قضاء فوائت التنمية هو واجب الوقت اليوم، وليس بالإمكان تأخيرها ولا ممارستها بنفس الأنماط السالبة، وإن من الغباء أن نتوقع نتيجة مخالفة للسابق، إذا مارسنا تجربة اليوم بنفس وسائل الأمس وأشخاصه وسياساته، لنخرج بنتائج هزيلة في إطار زمني طويل.
لقد عشنا طيلة العقود الماضية تحت رحمة تسيير اليوميات، وما تمليه علينا المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولم نختبر قط رؤية استيراتيجية وطنية قابلة للقياس والتقييم.
ومن أجل هذا كله وبأولوية ملحة جدا نحن بحاجة إلى حوار وطني شامل مع العقول والأدمغة الوطنية في الداخل والخارج، وفي يقيني إن حوارا من هذا النوع أولى وأجدر من كل الحوارات الأخرى، وينبغي أن يؤول هذا الحوار إلى قيام جبهة وطنية متماسكة ومتكاملة تعمل على تحقيق:
إعادة التأسيس والبناء على ما نملك من موارد بالغة الأهمية، ومن مصادر بشرية متعددة التكوين والكفاءات، وموارد طبيعية متعددة المنافع، وبنية دستورية وقانونية كفيلة بفرض حاكمية القانون وتحقيق العدالة.
والوصول إلى كل ما تقدم من اقتراحات يحتاج إلى إجرائين عاجلين هما:
إعادة الثقة في الدولة بحيث تترفع عن مخالطة الكيانات التقليدية المناقضة لوجود الدولة وهيمنتها الضرورية على ما سواها.
تحييد الوظائف والمراكز الإدارية والفنية عن الصراع والنقاش السياسي، ليكون معيار التعيين فيها والترقية هو الكفاءة والإنتاجية لا أكثر ولا أقل.
ولا يحتاج هذان الإجراءان إلا لإرادة صارمة من الرئيس المنتخب شرعيا وطبقا لصلاحياته الدستورية.
وأختم بتلك الحكمة التي يرددها سكان باديتنا أن السروال القديم يمكن لبسه مقلوبا لمرة واحدة، ولا يمكن تدويره بعد ذلك، وينطبق ذلك على أنماط الحكم وممارسة السياسية عندنا فقد حافظت على سنة التقليب والتدوير، وهي تجربة لا يجوز أن تستمر لا على مستوى الأشخاص ولا السياسات، فقد استنفد كل ذلك أعماره الافتراضية، وأصبح وسائل ضارة، ينبغي الابتعاد عنها.