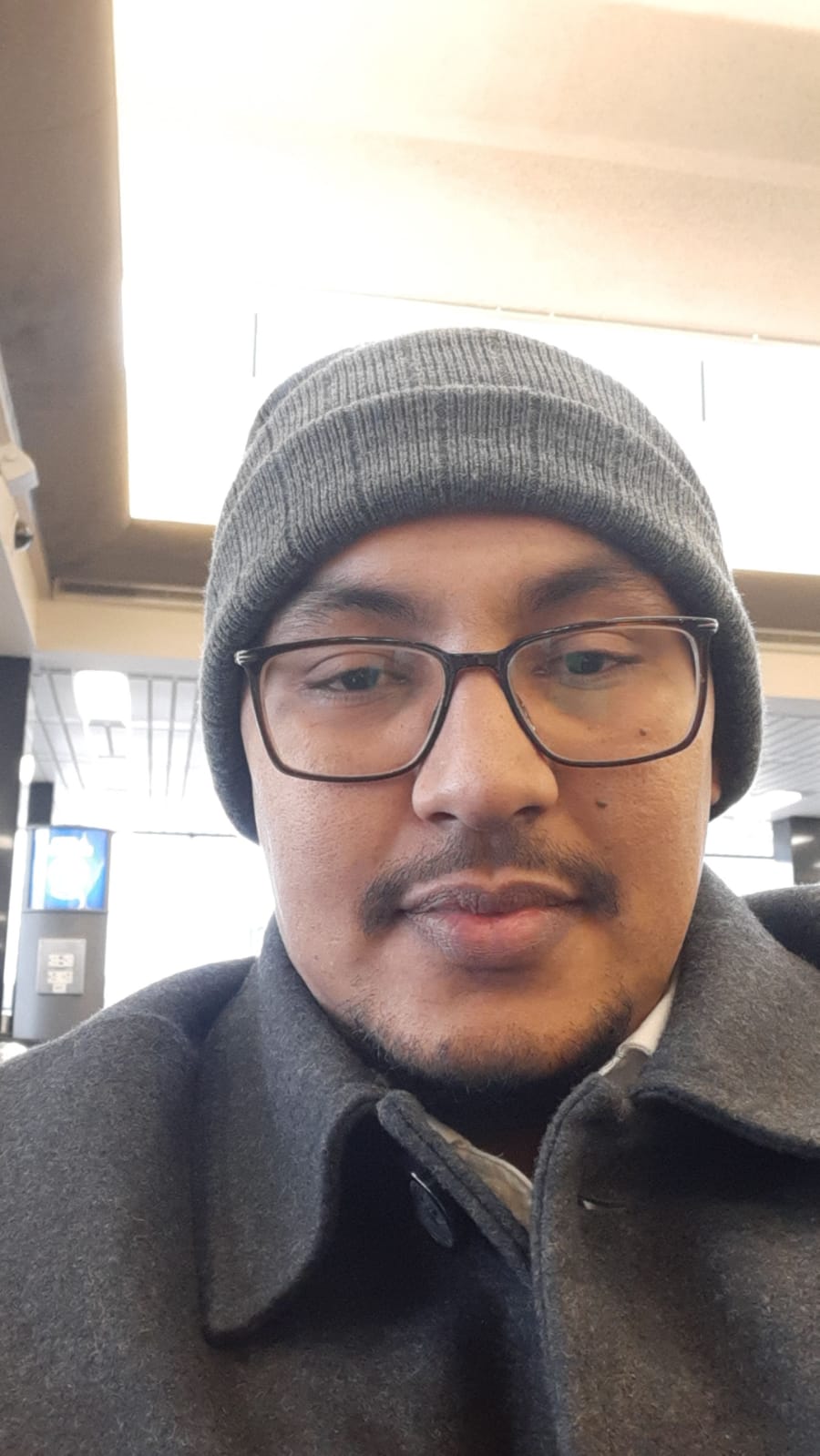
من المعاملات الماليّة الشائعة في بلادنا حسابُ الحوانيت، أو ما يُعرَف بـ"ركًلة آبّاتيك"، وقد دأب التُّجّارُ على التّعامل بها منذ ظهور تجارة الحوانيت إبّان حقبة الاحتلال الفرنسيّ، وهجرة الناس إلى السنغال وبعض البلدان الإفريقيّة؛ طلبا للرّزق وأسباب الغنى، فشاعت معاملة "ركًلة آبّاتيك" بين ملّاك المحلّات التجاريّة، والباحثين عن العمل، وانتشر التعامل بها، وتكرّر ذكرُها في الحكايات والأخبار، بل كانت سببا في بعض المساجلات الأدبيّة، كما كثُر السؤال عنها؛ فأثارت عنايةَ فقهاء البلد.
والعجيب أنّه مع تطوّر الوسائل والتنوّع الهائل في أساليب التعامل الماليّ لم تتغيّر هذه العادة التّجارية، بل ظلّت قائمةً حتّى اليوم، وبالطريقة نفسِها التي كانت قبل أكثرَ من قرنٍ من الآن.
في هذه الورقة نتحدّث عن "حساب الحوانيت"، نضعه في الميزان الفقهيّ الشنقيطيّ؛ لنتبيّن حقيقتَه، وحكمَه، ولنكشف جانبا من جوانب الإبداع في النظر عند السلف من فقهائنا، وكيف أعملوا قواعد الأصول، واعتبروا المقاصد، وخرجوا عن مشهور المذهب تيسيرا على الناس ورفعا للحرج.. وذلك من خلال المحاور الآتية:
تصوير المعاملة ووجه الإشكال فيها:
تطلق كلمة (رگله) أو "حساب الحوانيت" على المعاملة الآتية: أن يقومَ ربُّ مالٍ بتأجير حانوت ـمثلاـ ثم يشترى له البضائع التي يريد طعاما (مواد غذائية) أو عروضا (ثياب ، فرش..) ثم يتَّفِق مع عامل على أن يعمل في المحل ويتولّى إدارته والقيام على شأنه بيعا وشراء وقضاء واقتضاء.. مقابلَ جزء من ربحه يتَّفِقان على قدره، على أن يُحدِّدا فترةً زمنيَّةً، أو يجري بها عرفُ السوق؛ ليحين فيها وقت الحساب لتبيُّن الرّبح أو الخسارة.
ثمّ إنّه يتبادرُ إلى ذهن الناظر في صورة المعاملة الآنفة أنها قراضٌ (مضاربة) لما فيها من التوكيل على التجارة مقابلَ عوضٍ هو جزءٌ من أرباحها، ولكنها تصطدم ببعض الشروط والأركان التي تنبني عليها صحَّةُ عقد القِراض عند أئمّة المذاهب؛ فسُنّة القراض المعروفة أن يكونَ رأس المال فيه نقدا حاضرا معلومَ القدر والصفة.. إلخ، وهذا منعدِمٌ في المعاملة المذكورة، فالجاري به العرف أن تكون بعروض.
حساب الحوانيت (رگله) عند الفقهاء الشناقطة:
شيوع المعاملة المذكورة في منطقتنا فرَض على الفقهاء أن يتناولوها لكثرة السؤال عنها، ومع مخالفتها لما عليه الجمهور من المالكيّة وغيرهم، فقد تناولها فقهاؤنا ونزعوا فيها منازعَ المفتين الأكفاء بنظرٍ أصوليٍّ مقاصديّ يُراعِي المصلحة الحاجيّة، فبنوها على رفع الحرج، واعتبار عُرف التعامل الشائع؛ فأباحوها لعموم حاجة الناس إليها، ولننظر كيف صوّروا الواقع وأبانوا العُرف وشيوعَ المعاملة:
لقد سرد الفقيه عبد الحيّ ولد انتاب الإنتابيّ (تـ 1402هـ) أوجُهَ الحاجة الدّاعية إلى التعامل بـ"ركًله"، قال: "وقد حدثت نازلةٌ في أرضنا اشتدّت الحاجة إليها بين الفقراء وأهل الحوانيت، وهي أنّ أهلَ الحوانيت محتاجون لحفظ أموالهم، ولمن يبيع السِّلَعَ التي فيها، ويخلفها بأخرى للرّبح، ولئلّا تضيعَ بطول المُكث، ولئلّا يُهجَرَ محلُّ حانوته، وتُفتَح قربه الحوانيت لطول قَفله، ويحتاجُ لمن يقتضي دينه الذي يطالبُ به مجاوريه، وإن كان الحانوتُ مُكتَرى ولم يُعمَل فيه تجمَّعت عليه أجرتُه دون انتفاعٍ، إلى غير ذلك من الحاجات"، وقد عدّدَ غيرُ واحدٍ من الذين كتبوا عن المسألة هذه الأوجُهَ بطُرُق متقاربة.
وعلى هذا الأساس بنَى أغلب الفقهاء الذين وقفنا على فتاواهم الحكم بالجواز، يقول الأصوليّ المحقّق المختار بن ابلول الحاجيّ (تـ 1395هـ) مُعرِبا عن الحاجة إلى المعاملة، وأثَرِ ذلك في الحكم عليها: "اشتدت الحاجة فيها من الفقراء لسَدِّ خلَّتِهم ومن أهل المال لحفظ أموالهم"، منبِّها إلى أنّ أئمّة المالكيّة منذ دهورٍ طويلةٍ أجروا العملَ بإباحة صُوَرٍ من الإجارة المجهولة التي تؤول إلى معلومٍ لحاجة الناس إليها، قال: "وذكروا أنَّ إمامَنا مالكا (تـ 178هـ) رضي الله عنه نزَّلَ الأمر الحاجيَّ الكلِّيَّ منزلةَ الضروريِّ أيْ: الراجع إلى إحدى الضروريات الستِّ، والقاعدة الشرعيَّةُ أنَّ الضَّرورات تُبيحُ المحظورات".
وزيادة على ما سلف اعتبر ابن ابلول القولَ المرويَّ عن أحمد (تـ 241هـ) وطائفة من السلف بإباحة الإجارة المجهولة التي تؤول إلى علم؛ قياسا على القراض والمساقاة، واستند إلى قضيّة أصوليّة أخرى، هي: أنه إذا جرى عمل الناس على أمر وكان له مستند من قول العلماء فلا ينبغي أن يُعتَرَضَ عليهم، وإن خالف المشهورَ؛ لأنَّه يُورِث عليهم شَغَبا وحيرةً.
وعلى هذا المجرَى نفسِه جرى الشيخ محمّد عبد الله ابن الإمام الجكني (ت 1413هـ) فذهب في مسائله إلى أنّ "ركله" من باب القِراض كما يُعرف من تعريفه، ولكنّها قِراضٌ بالعروض، قال: "وقد منعه الجمهور، وأجازه ابن أبي ليلى" (تـ 148هـ).
كما أفتى بالجواز للاعتبارات الآنفة المصطفى ابن العيدِي التندغيّ (تـ 1419) ضمن جوابٍ له في نازلةِ شركةٍ تجاريّة، فأبان وجهَ الفساد في معاملة "ركلة" بناء على ما فيها من اختلال شروط القراض، ثمّ ذكر أوجُهَ القول بالإباحة، وذلك إذا "اعتبرناها إجارةً بمجهول جرى بها عملُ القُطر؛ للحاجة الماسّة لها من احتياج أرباب الحوانيت إليها لحفظ أموالهم، واحتياج العمّال جريًا على أصل المالكيّة من إباحة الكلّيّ الحاجيّ أيْ: الأمر العامّ أو الغالب في القُطر للاحتياج إليه".
وقد جمع الفقيه الحسن بن السيّد اليدالي (تـ 1424هـ) في أحكام "ركله" بأمرٍ من شيخه العلامة الشيخ محمّد سالم بن ألما (ت 1383هـ) نقولا حول أحكام القراض بالعروض ولو خارج المذهب، وتخلّص إلى الجواز اعتبارا للضرورة والحاجة، معتمِدا على ما تقرّر من أنّ عقدَ القراض كان شائعا في الجاهلية فأقرّه الإسلام، وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس، ونقل عن الفقيه الأندلسيّ ابن سرّاج (تـ 848هـ)، فتوى في جواز إعطاء الجِباح [جمع جَبحٍ: موضع إنتاج النحلِ العسلَ] لمن يخدُمُها بجزء من غلّتها، فأجاب بأنها إجارة مجهولةٌ، وكذلك الأفرانُ والأرحاء، وإنّما يجوز ذلك على قول من يستبيح القياسَ على القراض والمساقاة، قال: "وعليه يُخرَّجُ اليومَ عملُ الناس في أجرة الدّلّال لحاجة الناس لقلّة الأمانة وكثرة الخيانة"، ونقل أمثلةً عديدة لمعاملات مختلّة الشروط، وخارجة عن الأصل، وقد أجازها مُفتُو المذهب اعتبارا للحاجة والضرورة؛ ليجعل من سَنن الفقهاء في التعامل مع تلك النوازل أسوةً له في الحكم على النازلة محلّ البحث.
وقد ذهب العلّامة المفتي سيدي محمد (باي) بن سيدي أعمر الكنتي (تـ 1347هـ) في فتوى له عن حكم ما أسماه "الكارظة" إلى حرمة القِراض بالعروض بل والفلوس، تبعا للجمهور ووقوفا عند ما جاءت به السُّنّة من التزام القراض بخصوص العين، قال: ولم يلحقوا بها غيرَها لخروجه عن سنن القياس، إذِ القياس فيه المنع، وإنّما وردت الرّخصة في العين، والرخصة لا تَتَعدَّى محلَّها".
والواضحُ أن تشديدَ الشيخ الكنتيّ في المنع كان بسبب عدم جرَيان العُرف واشتداد الحاجة في أيّامه، إذ قال في النازلة نفسِها: "وقد جرى عملُ توات من قديم بالقراض بالعروض، ومنهم من يحتال لإجازة ذلك بحِيَل، فإن كان علماءُ ذلك القُطر ارتكبوا ذلك تقليدا لمن قال به ممّن شذّ من العلماء كابن أبي ليلى، لمحل الضرورة فإنّ لذلك وجهًا، إذا الضرورة العامّة تبيح ارتكاب غير المشهور، وأمّا أهل هذا القُطر فهم في غنى عن ذلك، فلا يحسن من أحدٍ العملُ به".
وهنا يشير إلى ما استند عليه الفقهاء السابقون في إباحة معاملة "ركله" ويُقرِّرُ الأصل الفقهيَّ له، ومن أخذ به من قبلُ، ولكنّه يُحذِّر من العمل به؛ لعدم الحاجة أو الضرورة الداعية له، ما دام أهلُ قُطره في غنى عنه.
مظاهر التحرّر والاجتهاد في الفتاوى السابقة:
يتّهِم كثيرٌ من الباحثين الفقهاءَ في بلادنا بالجمود المذهبيّ، والقصور في المباحث الأصولية، وفي النظر والاجتهاد، ولعلّ النازلة المذكورة –من بين نماذج أخرى– تُظهِر خلاف تلك الدَّعاوى، فقد جمعوا في الموقف منها بين التحرُّر من الجمود المذهبيِّ، وبين إعمال القواعد الأصولية، واعتبار المقاصد، وبيان ذلك في ما يلي:
1- التحرُّر من الجمود المذهبي: ويتجلّى في ما تكرّر في النقول السابقة من القول بجواز القراض بالعروض قياسا على الدراهم والدنانير، وهو قول لابن أبي ليلي (تـ 148هـ) والأوزاعي(ت157هـ)، معلّلين ذلك بأنها عينٌ تنمو بالعمل عليها؛ فصح العقد عليها ببعض أرباحها كالعين، وقد توسّع المنظِّرون لهذا الرأي في القياس حتّى قالوا: إنّ كلَّ عقد صحّ بالدراهم والدنانير صحّ بالعروض كالبيع.
2- إعمال القواعد الأصوليّة: وهو جليٌّ في تأكيد المفتين الشناقطة على اعتبار العرف الذي شاع في بلادهم، وتقرير أثَرِه على حكم النازلة محلِّ النظر، فمن المعلوم عند الفقهاء أنّ العرفَ مؤثّرٌ ومرَجِّحٌ للمرجوح من الأقوال، وقد نقل الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ) عن أبي سعيد بن لُبٍّ (تـ 782هـ) مفتى حاضرة غرناطة في القرن الثامن الهجري أنه كان "يُفتى بتقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك إذا كان له وجه ولو ضعيف من أقوال العلماء".
وهذه مسألة قررها الأصوليُّون من المالكية وأرجعوها إلى أصل "مراعاة الخلاف" كما أفتى بذلك الإمام الشاطبي.
3- النظر المقاصديّ: ونلحظُه في سعي المفتين إلى إيجاد المخرج الشرعيّ وإبعاد المشقّة ورفع الحرج عن الناس في معاملاتِهم، ولتحقيق ذلك استندوا إلى ما أسموه "الحاجي الكلّيّ" أي الحاجَة العامّة في إباحة العقد المذكور، وهو أصل توسّع المالكية كثيرا في بناء الفروع عليه، وعدّوه في القواعد والأصول التي تنبني عليها أحكام البيوع والمعاملات، يقول ابن العربيّ (تـ 543هـ): "القاعدة السابعة اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم"، ويقول المواق بعد أن نقل أمثلة من الإجارات المجهولة : "ومن أصول مالك أنه يراعي الحاجيات كما يراعي الضروريات"، ثم يسوق نماذج مما نقل عن الإمام وتلاميذه من إجازة بعض العقود الممنوعة للحاجة إليها مثل تأخير النقد في الكراء المضمون.
وتناول الإمام الشاطبي (تـ 790هـ) هذا الأصل بشيء من التفصيل أثناء حديثه عن قاعدة الاستحسان قائلا: "وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنَّه أُبيح لما فيه من الرفق والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيقٌ على المكلفين [...] وسائر الترخصات التي على هذا السبيل، فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد".
وقد أخذ به سائر فقهاء المذاهب من الحنفية والشافعية وغيرهم حتى إن المتأخرين من أتباع الإمامين مالك وأبي حنيفة يتوسعون في التعامل مع المصالح الحاجية أحيانا مع مخالفة نصوص الإمام بناء على ما فهموه من قواعد إماميهما.
فالاعتماد إذا على المصلحة الحاجيَّة، والاستناد لها في مثل هذه الأحكام لسدِّ الحاجة العامة ورفع الحرج والضيق عنهم أمر أقَرَّه الشَّرعُ، وعمِل به الأئمّة.
وفي الختام:
هذا مثالٌ من أمثلةٍ كثيرة ونماذجَ وافرةٍ تكشِف للباحث جوانبَ النظر الأصوليّ والمقاصديّ في النوازل والفتاوى الشنقيطيّة، وتردّ ادّعاءات طالما ردّدها بعض الناس بأصوات صاخبةٍ دون بيّنات.















