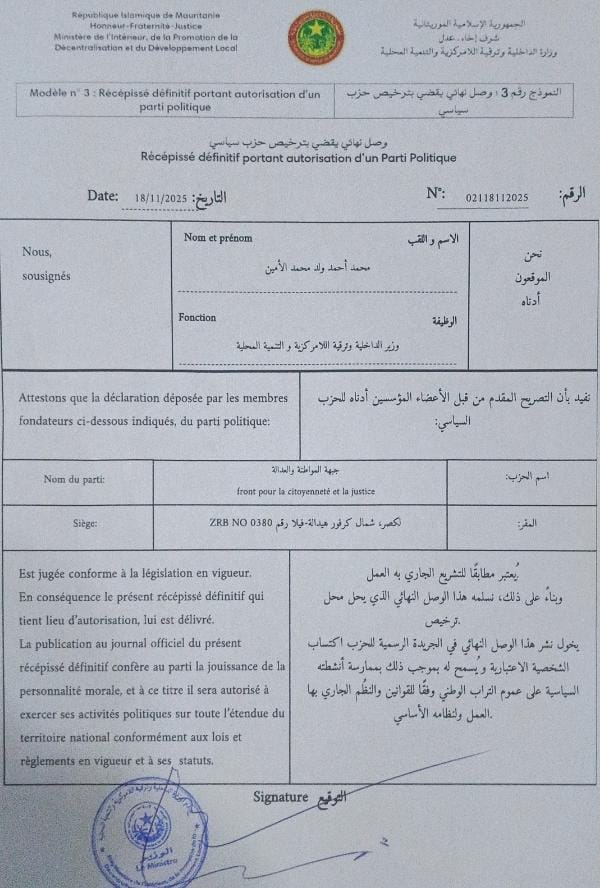أعلنت فرنسا منذ اسابيع تعليق تعاونها العسكري مع مالي بجميع اشكاله: سواء تعلق الأمر بالعمليات المشتركة مع الجيش المالي، أو تعلق بتقديم الدعم التقني. وجاء قرارها استنكارا ورفضا للانقلاب العسكري الأخير في مالي، وتعبيرا ضمنيا عن عدم سرورها بموقف مجموعة دول غرب افريقيا من الموضوع.
الكيل بمكيالينك:
بينما باركت الانقلاب على الدستور الذي وقع في تشاد فور موت ادريس دبي، عندما تولى ابن هذا الأخير قيادة البلد بدلا من رئيس الجمعية الوطنية، الذي ينص الدستور على أنه هو من يخلف الرئيس في حالة وقوع عائق يمنع هذا الأخير من مزاولة وظيفته.
والتفاوت الصارخ في الموقف الفرنسي من الوضعين في تشاد وفي مالي يظهر أنها تنتهج تكتيكات الكيل بمكيالين في سياستها الخارجية مما ينم عن عدم ثبوت في الرؤية الجيواستراتيجية. وعلى صعيد آخر، يشكل رفضها للحوار بين السلطات في مالي و"الجهاديين" أحد ملامح هذا الضعف والكيل بمكيالين، فهي تدعم ما جرى بين الحكومة الأمريكية وحركة الطالبان في أفغانستان، بل عملت بمقتضى الاتفاق بين الطرفين، لأنها سحبت قواتها التي كانت ترابض وتقاتل إلى جانب الأمريكيين هنالك.
التخبط ومحاولة تغطية الضعف:
من أهم الثوابت للاستراتيجية العسكرية الفرنسية الموجهة إلى افريقيا ومنطقة الساحل، أنها غير ثابتة على حال، لأنها تتغذى على ماض ولَّى وتراث استراتيجي في تقهقر مستمر. من آخر مؤشرات ذلك قرار أعلنت عنه يوم أمس وزيرة الجيوش. فقد أصدرت السيدة "فلورانس بارلي" بيانا جاء فيه أن فرنسا تأخذ في الحسبان وبعين الرضى "التزامات السلطات المالية الانتقالية" التي أقرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" وأنها " قررت استئناف العمليات العسكرية المشتركة" ومهمات التعاون الأخرى بما فيها "البعثات الاستشارية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو".
ومن المثير للتساؤل أن قرار تعليق التعاون العسكري مع مالي كان منذ البداية مفاجئا وغير مبرر بالنظر للوضع في البلد وفي المنطقة. وكذلك فإن قرار استئنافه من جديد محير هو الآخر. فلم يتغير شيء في مسار العسكريين الذين يقودون البلد خلافا لما يحاول بيان وزارة الدفاع الفرنسية إيهام الرأي العام به: الوعود التي اخذوا منذ أول لحظة على أنفسهم بشأن المرحلة الانتقالية ما زالت كما هي. فلا جديد في الوضع سوى أن تعثر فرنسا وتخبطها في الساحل يتأكدان أكثر فأكثر. ولا يقتصران على علاقتها مع مالي، بل يمسان جميع مناحي رؤيتها الجيو سياسية في افريقيا. فهي حائرة بين البقاء والخروج، بين التظاهر بالقوة والخنوع لحقيقة وزنها المتناقص على الساحة الدولية منذ عشرات السنين أو أكثر.
على طرق مسدودة...
فبعدما شن الرئيس السابق فرانسوا هولاند عملية "سرفال" في 11 يناير عام 2013، وأعلن بفخر واعتزاز قصم ظهر ارتال "الجهاديين" التي كانت حينها "على مشارف باماكو"، وطردهم من المدن في شمال مالي، واعتبر آنذاك أن النصر قريب؛ فقد تبين أن الامر ليس بتلك السرعة والسهولة. فعززت فرنسا قواتها من جديد وحولتها في فاتح أغسطس 2014 إلى عملية أسمتها "برخان" قوامها بلغ أخيرا أكثر من 5000 جندي. ثم صارت بعد ذلك تطلب العون من دول المنطقة، وتحثها على التعاون المتين عسكريا فيما بينها، وتدعم بكل ما أوتيت من قوة الأنشاء والتفعيل السريعين "لقوة عسكرية مشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس". وطبعا، التقت المصالح الاستراتيجية والأمنية لتلك الدول مع محاولات فرنسا الخروج شامخة الرأس من المستنقع العسكري في الساحل. غير أن الأوضاع لم تتحسن، بل إن "الجهاديين" استرجعوا كثيرا من قوتهم، وكثفوا هجماتهم، واتسعت باستمرار رقعة انتشارهم.
فعمدت فرنسا إلى مناورات أخرى: سياسية وعسكرية، عساها تكون أقل كلفة. فنراها تخطط لتقليص "برخان"، وتطلب النجدة العسكرية من حلفائها الأوروبيين عبر أنشاء قوة "تاكوبا" الخاصة. ولن يكون لها فيها النصيب الأكبر، فحسب، بل إن "تاكوبا"
ستتكون أساسا من جنود وآليات فرنسية، حيث ستندمج فيها القوات المتبقية من برخان. غير أن هذه الخطة أو البرمجة، التي أعلن عنها الرئيس مانويل ماكرون وأعوانه والخبراء الفرنسيون، قابلة للتغيير. فالأوروبيون غير متحمسين لها. أما قادة دول مجموعة الساحل الخمس، فإنه من اليسير تصور حيرتهم من تقلبات الموقف الفرنسي. بل لا يستغرب أن ينزعجوا منه، خاصة أن كثيرا من المراقبين يتهمون مانويل ماكرون بعدم التشاور كما ينبغي مع نظرائه الأفارقة. بل يقول مُتهِموه أنه يبدى تجاههم نوعا من عدم الاحترام، لئلا نقول نوعا من الازدراء. وعلى سبيل المثال، فإن المراقبين ينتقدون أسلوبه الخشن والمتعالي حين أعلن "استدعاءه" لقادة مجموعة الساحل الخمس لقمة "أبو" التي عقدت في جنوب فرنسا في يناير من العام الماضي. كما لوحظ عدم ذكره لهم أو للقوة العسكرية المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس طيلة المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه عن نهاية "برخان".
وفي الحقيقة، قد يكون لقول متهميه نصيب لا يستهان به من الحقيقة، علما أن التواضع لا يشكل الخصلة الأولى للسيد ماكرون. لكن سلوكه قد يؤل على نحو آخر، وإن كان لا يتعارض مع ما سبق ذكره:
سفينة السياسة الخارجية لفرنسا متعثرة جدا في منطقة الساحل، وتتقاذفها موجات التخبط الأعمى وغياب رؤية استراتيجية واضحة، مثمرة وفعالة. ولا شك أن ربانها في حيرة من أمره. فلا هو يستطيع مواصلة النهج وما يحمله من عقبات ومخاطر جسام، ولا هو بقادر على إيجاد مسار بديل يُخرٍج قواته من "المستنقع الساحلي"، ويصون المصالح الجيواستراتيجة لبلاده في المنطقة وفي افريقيا.
الأعداء والمنافسون يتربصون بفرنسا الدوائر
سيرى "الجهاديون" لا محالة ضعفا كبيرا في تذبذب الاستراتيجية الفرنسية وتناقضاتها تجاههم وتجاه حلفاء فرنسا من الدول الإفريقية. وقد بادروا باستغلال الموقف، ولن يُفوٍّتوا أي فرصة: عسكرية كانت أم سياسية. فانتعاشهم وحيويتهم العملياتية والاتساع المستمر لحيزهم الجغرافي، كلها أدلة على أنهم يستغلون الوضعية الراهنة جيدا.
وجميع المؤشرات توحي بأنهم سيستفيدون منها أكثر فأكثر، خاصة في ظل التراجع العسكري الفرنسي المنتظر وعدم الاستقرار السياسي في بعض دول المنطقة. ومن جهة أخرى فإن قوة الجماعات المتطرفة المسلحة، المتزايدة يوما بعد يوم، لم تتضرر إلا قليلا من الصراعات الدامية داخلها. بل إن المعارك التي وقعت على سبيل المثال بين "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" من جهة، و"الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" من جهة أخرى، وداخل طوائف بوكو حرام كذلك، تشير إلى أن تلك الجماعات بلغت حدا من القوة يكاد يكون من المستحيل معه التعايش فيما بينها في فضاء مشترك. فكل واحدة منها تريد تحصين حيزها الجغرافي والبشري. ولم يفلح أعداؤهم، وخاصة فرنسا، من الاستفادة من صراعاتهم الداخلية. وكيف لفرنسا بذلك، وهي تحرم أي تعامل غير العنف العسكري مع تلك الجماعات المسلحة!
أما على صعيد الصراعات الجيوسياسية التقليدية بين الدول، فإن فرنسا معرضة لمنافسة شرسة في المنطقة.
فالروس والصينيون والأتراك… يراقبون الوضع في منطقة الساحل عن كثب. ولكل منهم آلياته السياسية والاستراتيجية. فقد حل جيش من"المرتزقة" الروس، تحت راية شركة "فاگنير"، محل الجنود الفرنسيين في جمهورية إفريقيا الوسطى. ومما لا شك فيه، أنهم الآن يتطلعون إلى مالي والمناطق الافريقية الأخرى التي يتضاعف فيها الوجود الفرنسي والغربي، أو يثير جدلا. والصينيون أيضا في كمين، يتحينون الفرص في مالي وغيره، بهدوء، ماكرين ومرنين.
أما الأتراك، فلن يبخلوا جهدا في لعب أوراقهم. ومن أهمها ملء الفراغات السياسية الناجمة عن الرفض المتشدد للمفاوضات مع "الجهاديين" الذي يسعى ماكرون عبثًا إلى فرضه على دول الساحل. ففي ضوء تلك المفاوضات التي تبدو حتمية، لا سيما مع الحكومة المالية، يشحذ نظام طيب أردوغان "الإخواني"[i] أسلحته لكسب موطئ قدم في المنطقة. ويشكل وجوده العسكري في ليبيا قاعدة خلفية ولوجستية للحركات "الإسلامية" وعلى رأسها "الإخوان المسلمون". هذا بالإضافة إلى أن بلاده لديها نقاط قوة لا يستهان بها: تركيا اصبحت قوة جهوية صاعدة تطمح إلى أن تكون لها مكانة بين الفاعلين المؤثرين دوليا على المستويات الجيوسياسية.
وتفاعلا مع هذه الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة باستمرار، ستكون نظرة الدول الأفريقية متعددة الاتجاهات. فاليوم ترتفع أصوات، كثيرة ومتزايدة في هذه البلدان، تدعو إلى تعدد الشركاء والحلفاء وإلى تنويعهم. ونجد لها أصداء إيجابية في العولمة ومخلفاها، التي لم تعد معها دول الساحل والدول الأفريقية "حكرا" أو "محمية" لدولة معينة، خلافا لما سارت عليه في الماضي علاقاتها مع المستعمر السابق. وهذه حقيقة جيوسياسية بديهية يجب على القوى العظمى السابقة أو اللاحقة، والدول الناشئة والدول النامية أن تتفاعل معها بحكمة وفعالية. وبصورة خاصة، يجب على فرنسا ألا تتجاهلها إن هي أرادت لنفسها ألا تخسر "معركة الساحل وافريقيا"، حيث تبدو الآن مهددة بفقدانها إن تمادت في تخبطها الأعمى. كما ينبغي على دول الساحل أن توظف هذه المعطيات المتغيرة بفعالية وتواكب وتيرتها بشكل جيد.
[i] نسبة إلى الإخوان المسلمين. وفضلنا كلمة " اخواني" على "إسلامي" لتمييز تلك الحركة عن غيرها من مزاولي الإسلام السياسي، كما فضلناها على كلمة "إخونجي" الشهيرة نظرا لما تحمله هذه الصفة من شحنات سلبية.
تصنيف: