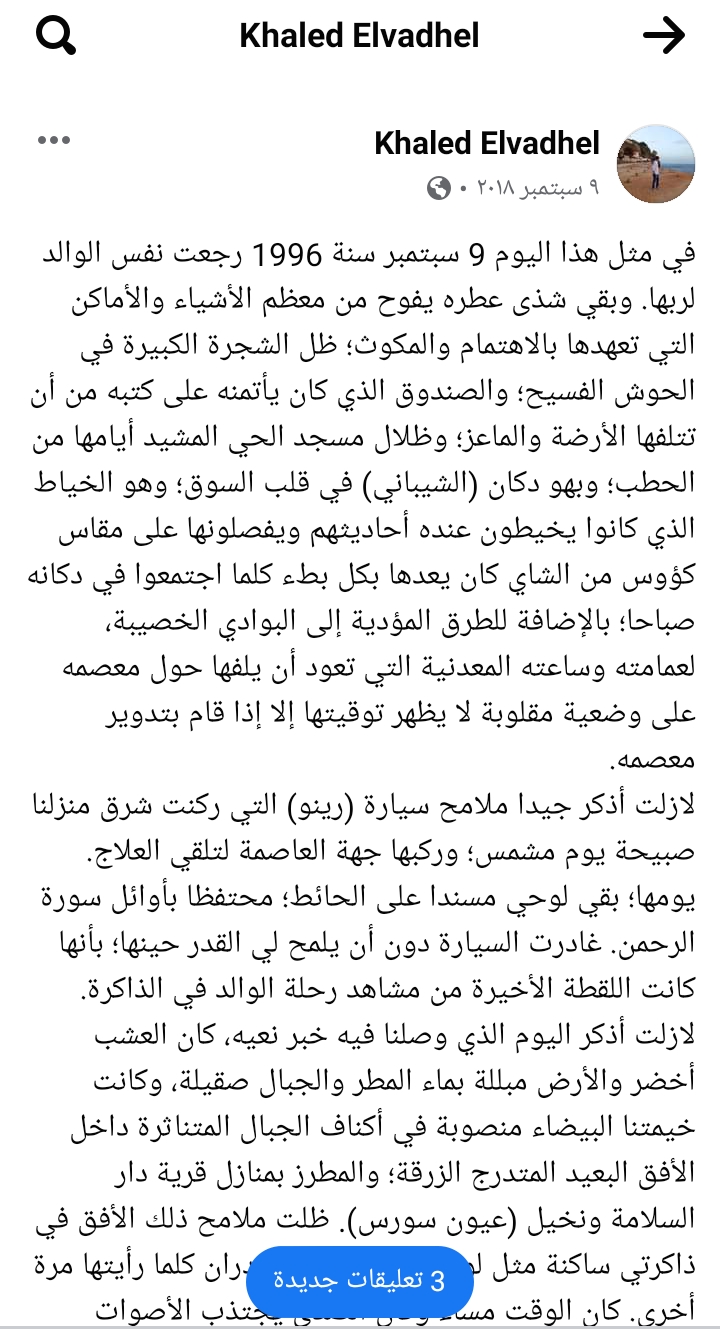
في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر سنة 1996 رجعت نفس الوالد لربها. وبقي شذى عطره يفوح من معظم الأشياء والأماكن التي تعهدها بالاهتمام والمكوث؛ ظل الشجرة الكبيرة في الحوش الفسيح؛ والصندوق الذي كان يأتمنه على كتبه من أن تتلفها الأرضة والماعز؛ وظلال مسجد الحي المشيد أيامها من الحطب؛ وبهو دكان (الشيباني) في قلب السوق؛ وهو الخياط الذي كانوا يخيطون عنده أحاديثهم ويفصلونها على مقاس كؤوس من الشاي كان يعدها بكل بطء كلما اجتمعوا في دكانه صباحا؛ بالإضافة للطرق المؤدية إلى البوادي الخصيبة، لعمامته وساعته المعدنية التي تعود أن يلفها حول معصمه على وضعية مقلوبة لا يظهر توقيتها إلا إذا قام بتدوير معصمه.
لازلت أذكر جيدا ملامح سيارة (رينو) التي ركنت شرق منزلنا صبيحة يوم مشمس؛ وركبها جهة العاصمة لتلقي العلاج. يومها؛ بقي لوحي مسندا على الحائط؛ محتفظا بأوائل سورة الرحمن. غادرت السيارة دون أن يلمح لي القدر حينها؛ بأنها كانت اللقطة الأخيرة من مشاهد رحلة الوالد في الذاكرة.
لازلت أذكر اليوم الذي وصلنا فيه خبر نعيه، كان العشب أخضر والأرض مبللة بماء المطر والجبال صقيلة، وكانت خيمتنا البيضاء منصوبة في أكناف الجبال المتناثرة داخل الأفق البعيد المتدرج الزرقة؛ والمطرز بمنازل قرية دار السلامة ونخيل (عيون سورس). ظلت ملامح ذلك الأفق في ذاكرتي ساكنة مثل لوحة معلقة على الجدران كلما رأيتها مرة أخرى. كان الوقت مساء وكان الصدى يجتذب الأصوات القادمة من بعيد؛ سمعنا صوت سيارة يقترب ويتصاعد، كانت سيارة (لاندرفير) فضية، نزل رجال من حوضها بعضهم لم يكن مألوفا، كان النعي في نظراتهم قبل أن تنطقه شفاههم. عندما أذاعوا الخبر؛ بدأ النحيب الخافت يسمع من مكان قريب. كنت ساعتها أعتلي كثيبا قريبا من الخيمة، كنت مشغولا في بناء بيوت من رماله المبللة؛ أحيانا كنت أكمل بناءها؛ وأحيانا أسقطها عندما لا يعجبني تصميمها!
في ذلك المساء هرولت عنها قبل أن أتخذ حيالها موقفا ما، كان يطاردني فضول شديد لمعرفة السر وراء قدوم السيارة لخيمتنا بالتحديد؛ ووراء ذلك النحيب الذي سمع مع نزول ركابها، والأهم من ذلك كله؛ مصافحتهم؛ لعل الأمتعة التي نزلوا بها تكون محملة بالهدايا.
كنت ارتدي سروالا أبيضا من الجينز لا يتجاوز الركبتين كثير الأزرار والجيوب، كنت اشتريته من محل الملابس المستعملة( فوكو جاي)، لكنني؛ لا أتذكر لون قميصي وشكله مطلقا في ذلك المساء البعيد.
ضاقت الخيمة بزوارها، ففرشوا الحصائر حولها وتقاطر الجيران في باديتنا إليها. عندئذ؛ رأيت الأسى يخيم على قسماتهم، رأيت الحزن يخبو مع جمل المواساة ويتفاقم كلما جاء شخص جديد لتقديم العزاء. لم أر ظلال الحزن تمتد في قلبي، كان حزني يشبه بذرة صغيرة زرعت في الحقل لتوها، كأن الحزن كان ينتظرني حتى أكبر وأتقدم في العمر لكي ينمو ويكبر معي.
لم أكن أدري ما حقيقة الموت وطبيعته؟، لم أتصور بأنه غياب لا عودة منه، تصورته يشبه الأسافر الطويلة؛ وأن من غيبهم سيعودون حتما ذات يوم محملين بأثمن الهدايا وأجملها. لكن؛ وبعد 22 عاما من الغياب؛ لم يعد الوالد رحمه الله؛ بينما تحولت تلك البذرة الصغيرة إلى شجرة كبيرة امتدت ظلالها داخل قلبي ووجداني، بعدما أعياها الوصول إليهما في ذلك المساء البعيد من شهر سبتمبر سنة 1996. فحينما كنت أبني منازلا هشة من الرمال المبللة؛ متخذا منهما لهوا ولعبا؛ لم أدرك بأنها لا تختلف كثيرا عن منازل العمر التي نقوم بزخرفتها طيلة وجودنا العابر في الحياة..
الحياة لن تحتفظ إلا برائحة قلوبنا وآثار سواعدنا، وكلما خلفنا رائحة طيبة وآثارا نافعة؛ تمددت ظلال أرواحنا في اتجاهين متعاكسين؛ هما الحياة من ورائنا والعالم الآخر من أمامنا. رحم الله الوالد برحمته الواسعة.
هنا نواكشوط. والساعة 20:45 وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.















